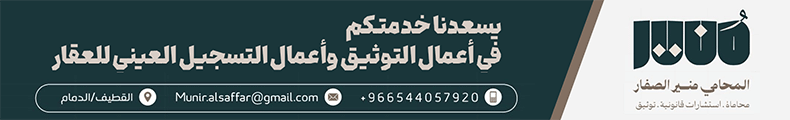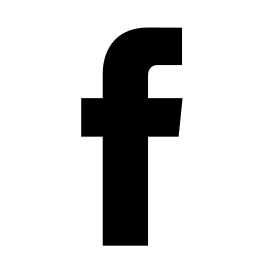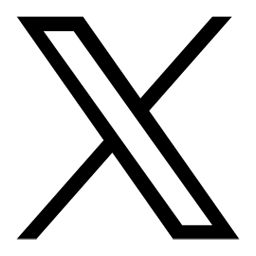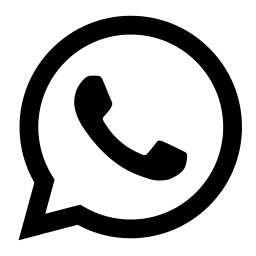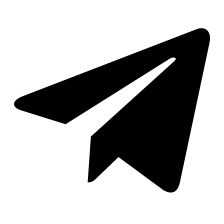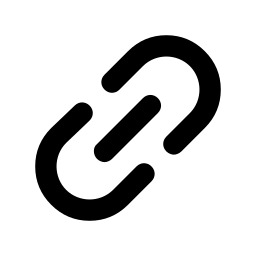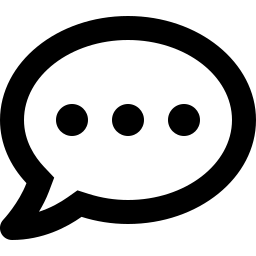لا زلت في وجداننا يا نعم الرجال وستظل
بالأمس القريب، كنا نتبادل أطراف الحديث مع بعض الإخوة الأفاضل في إحدى الديوانيات، وبينما كنت أتصفح رسائل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وردتني صور أرسلها لي بعض الإخوة، توثق لقاءً أخويًا في زيارة ودية للحاج سعود عبدالله مناسف «أبو عبدالله»، للاطمئنان على صحته إثر وعكة ألمّت به وألزمته المنزل. لقد خلف غيابه فراغًا لا يُعوَّض في نفوس محبيه ومريديه، كيف لا، وهو من خيرة الرجال المتحمسين والنشطين، المتطوعين والمثابرين في ميدان العمل الخدمي المتنوّع.
كان الحاج سعود، بحق، أشبه بخلية نحل لا تهدأ، حاضرًا في كل مناسبة اجتماعية، مشاركًا في مختلف الفعاليات، خادمًا متشرفًا في مجالس الإمام الحسين  ، ومساهمًا في الأفراح والأتراح، يسارع إلى أداء ما تيسر له من مهام خدمية بإخلاص وتواضع. تنقّل بين الأماكن سيرًا على قدميه دون كلل أو ملل، مدفوعًا برغبة صادقة تسكن وجدانه، ومقصده وجه الله سبحانه وتعالى، سعيًا في الأجر والثواب، دون انتظار مقابل مادي أو حتى كلمة شكر.
، ومساهمًا في الأفراح والأتراح، يسارع إلى أداء ما تيسر له من مهام خدمية بإخلاص وتواضع. تنقّل بين الأماكن سيرًا على قدميه دون كلل أو ملل، مدفوعًا برغبة صادقة تسكن وجدانه، ومقصده وجه الله سبحانه وتعالى، سعيًا في الأجر والثواب، دون انتظار مقابل مادي أو حتى كلمة شكر.
كل ذلك لم يكن إلا انعكاسًا لمعدنه الأصيل، وجوهره النقي، وقلبه العامر بالحب، ونفسه الممتلئة رحمةً وحنانًا لمن حوله.
أفلا يجدر بنا، كمجتمع، أن نكرّم هذا الرجل المعطاء؟ أن نمنحه أوسمة الشرف، مادية كانت أو معنوية؟ لا لشيء سوى لأنه رمز للبساطة والتواضع، زاهد في حطام الدنيا، راضٍ قانع، متواضع في نفسه وخصاله.
إن ما قدمه الحاج سعود من زيارات ومشاركات وخدمات جليلة لأهله وأبناء مدينته، دليلٌ ساطع على طِيب جوهره وأصالة معدنه. ومثل هذه النماذج الإنسانية النادرة جديرة بأن تُكرّم ويُحتفى بها، وهذا أقل ما يُقال في حقه، فهو عنوان مضيء ورمز يُحتذى به، بجهوده النبيلة ومبادراته الكريمة. وهو العفيف الشريف الذي لم يمدّ يده لأحد، كائنًا من كان.
نسأل الله تعالى أن يمدّ في عمره أعوامًا مديدة، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، بحوله وقوته.